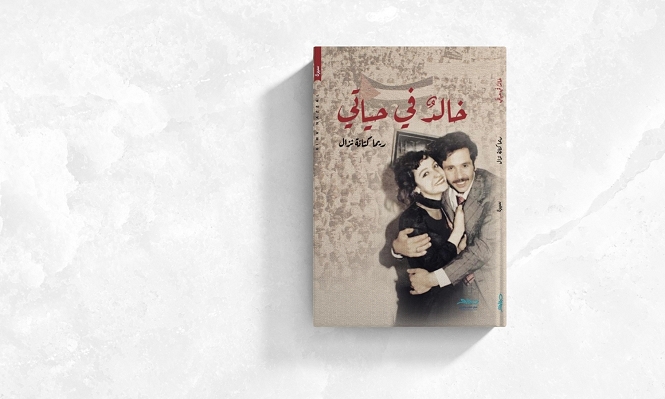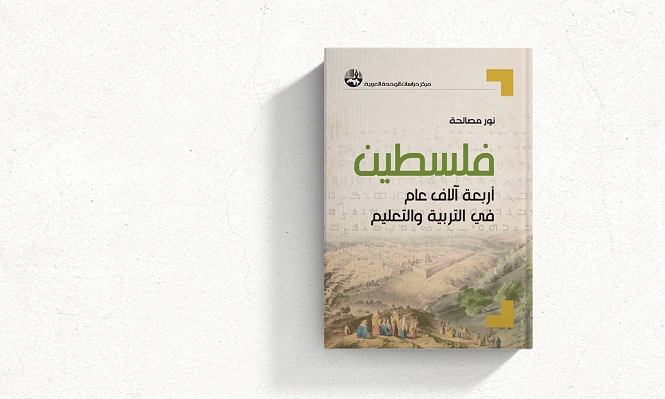سماء القدس السابعة | رواية

صدرت حديثًا عن «منشورات المتوسّط» في إيطاليا، رواية جديدة للكاتب الفلسطينيّ أسامة العيسة، بعنوان: «سماء القدس السابعة».
يعود العيسة في الرواية إلى قُدْس السبعينات الّتي تتعرّض إلى ما يشبه المجاعة، للمرّة الثانية، بعد خروجها من الحرب الثانية خلال عشرين عامًا، وهي تحاول احتواء صدمتها مع محتلّها المنتصر، والمتفوّق.
تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الرواية بإذن من الناشر.
حُلْوَة وادينا!
أعجبني اسم ’حُلْوَة‘، يُطْلَق على وادينا، وعندما كنت أسأل والدي عنه، يقول لي: "سأروي الحكاية لاحقًا". حتّى كان ذلك اليوم التمّوزيّ الحارّ الّذي قابلنا فيه الشيخ عبد ربّ النبيّ، ولُذْنا من الحرّ في الليل إلى سطح منزلنا، واستلقيت على فرشتي وفي حضني القطّة وزّة، أنظر إلى النجوم، بينما تمدّد والدي بجانبي، ووضع يده على رأسي، وبدأت أصابعه تتخلّل شعري، وهو يقول:
"وادينا هذا، الّذي نقطعه معًا كلّ يوم، في صعودنا إلى القدس، كان اسمه وادي النبّاحة، وعلى قمّته بُنِيَتْ القدس القديمة، ليست القدس المسوّرة الّتي تعرفها، وإنّما أوّل قدس، كما كشف الآثاريّون أوّل أرض، وأوّل لبنة، وأوّل ناس. أجدادنا كانوا يسمعون في الليل أصوات حيوانات تنبح دافعة الخطر عن نفسها، محذّرة غيرها من الحيوانات، أو تنوح كابن آوى الّذي كرهه أهلنا لغاراته الّتي لا تنتهي على أقنان الدجاج، ولكنّهم لم يتمنّوا لبنات آوى الموت، وسرى على ألسنتهم مثلًا: "ربّنا بيكسر جمل عشان عشوة واوي"؛ إيمانًا منهم بأنّ كلّ مَنْ خلقه الله له الحقّ في الحياة، وبأنّ الله يتدبّر توفير الطعام لخلقه بطريقته؛ فلم يخلق الله مخلوقاته ليجوّعهم، وإنّما لغايات أرادها سبحانه. ورغم الإزعاج الّذي تسبّبه هذه الأصوات للفلّاحين الّذين ينامون باكرًا، ليصحوا أبكر ويذهبوا إلى بساتينهم في منطقة البساتين؛ فإنّهم لم يحاولوا، ولو مرّة، الخروج ومواجهة الحيوانات، الّتي تزيد من أصواتها كلّما تقدّم الليل، وكأنّها تتحدّاهم؛ فذلك الزمن لم يكن كزماننا، كانت الدنيا أوحش، والليل أحلك، والخوف كابح مقيِّد، حتّى جاء يوم خرج فيها شيخ الشباب، واحد سبع مثل عمّك السبع هوايته مناطحة الصخر، ولا يخشى مؤامرات الإنس، ولا عواقب انتقام الجنّ، محمّلًا بشغف إظهار نفسه مدافعًا وحاميًا لروح الجماعة. وبعد أن تقدّم قليلًا مبتعدًا عن العين ومنازل القرية، شاهد شبحًا يدعوه إلى مواصلة السير، فتخيّله ضبعًا سيرشقه ببوله ويضبعه فينقاد خلفه إلى وكره، وهناك سيلتهمه، ويفصّص عظامه. ولكنّه عندما رأى الشبح وتأكّد من هويّته، تذكّر تلك الواقعة الّتي سمع بها من جدوده، حول قتل شقيق لشقيقته الجميلة، الّتي اتّهمتها نساء القرية بشرفها؛ للتخلّص منها بسبب جمالها الفتّان القادر على إغواء رجال القرية الوسيمين".
تأكّد والدي إذا ما كنت ما زلت مستيقظًا، وقد لاحظ انتظام أنفاسي، الّتي حاولت كبتها حتّى لا أضيّع على نفسي حرفًا ممّا يقوله والدي، مستهجنًا ما بدر من نساء القرية الشرّيرات.
أكمل والدي: "شيخ شباب بلدنا في ذلك الزمان، وجد نفسه منقادًا خلف المرأة، وشعر بأنّه يفعل ذلك بدون إرادته، وكأنّها الندهة الّتي تسحب الرجال إلى هلاكهم. بعد مسير لن يستطيع تقدير طوله أبدًا، كلّما روى الحكاية لاحقًا، توقّفت المرأة أمام كهف؛ فأصبح وجهًا إلى وجه أمام المرأة الجميلة الّتي لم يتغيّر جمالها، بينما بدّلت قريتنا مئات الرجال والنساء، ودفنتهم بجوار سور القدس. سألها وأجابته، وقال لها وقالت له، لكنّه لم يفصح عمّا دار بينهما، تاركًا للمخيال الشعبيّ أن يؤلّف، ويعقّد الحكايات. المهمّ أنّ شيخ الشباب لم يَعُدْ تلك الليلة، وعندما قلق عليه الأهالي، خرجوا يبحثون عنه نهارًا، وفتّشوا كلّ الكهوف المحيطة بالقرية، أو الّتي يعرفونها، فليس كلّ الكهوف تكشف نفسها لناس القرية، وفتحوا القبور الرومانيّة الفارغة، ولكنّهم لم يجدوه، فغامر محبّوه من الشباب، وخرجوا ليلًا، وهم يحملون المشاعل، ولكنّهم فشلوا مرّة أخرى في إيجاده، ورفعوا أصواتهم عاليًا باسمه، وكان يمكن سماعها في منازل القرية النائمة، لكي يُطَمْئِنوه إذا سمعهم، وليُطَمْئِنوا أنفسهم، ويبدّدوا وحشة الليل. بعد يومين فاجأ شيخ الشباب الناس وهو يتقدّم من منازل القرية، فالتفّوا حوله يسألونه عن الخبر، فقال لهم: يا أهل القرية الجبانة، كنت عند قتيلتكم المظلومة. وروى لهم كيف أنّ ليلى الّتي قتلها شقيقها ظلمًا، ما زالت تعيش حول القرية، من خلال شبحها الّذي يصرخ في الليالي غضبًا على الظلم، ناشدًا العدالة، مذكّرًا الأهالي بما ارتكبوه في حقّها، ومدينًا للرجال الّذين سمعوا رأي نسائهم الغيورات من جمال ليلى، الّتي ستظلّ تنوح وتنبح، حتّى تتمدّد منازل القرية، وتبني البعثات التبشيريّة كنائس، وتغيب ليلى وشبحها عن وادي النبّاحة؛ فقد أدّت دورها، وبعثت برسائلها إلى العائلات، لكن يبدو أنّها لم تكن مؤثّرة. أمّا هي فهذا حسبها، وما استطاعته فَعَلَتْه، قبل أن تعود إلى مستقرّها الأخير، وتقرّر ألّا تزعج أهالي القرية النائمين، فمهما فعلت فإنّهم لن يتغيّروا، فأراحت نفسها وأراحتهم".
تأثّرت للنبّاحة الّتي قال والدي إنّها قد تكون واحدة من جدّاتي القديمات، فأهل القرية في النهاية، ينحدرون من نفس الأصلاب، الّتي عاشت هنا، وشربت من ماء العين، وأكلت من البساتين، وكان عليهم استيعاب صدمات الفاتحين والغزاة، كما يفعلون الآن مع الاحتلال الجديد.
فرحت بجدّتي القديمة الجميلة المظلومة، الّتي لم تستسلم لِما حلّ بها بسبب الغيرة، وظلّت تُقْلِق ليل الظالمين، الّذين صمتوا على الظلم، ولتقول لمَنْ يريد أن يعي مثلي، إنّه ليس أسوأ من الظلم، والظلم ظلمات، كما كانت أمّي تردّد دائمًا.
قال والدي: "نساء بلادنا ظُلِمْنَ كثيرًا من مجتمعهنّ الذكوريّ"، ولم أُوقِف والدي لأسأله ماذا يقصد بالذكوريّ، مؤجّلًا ذلك إلى فرصة أخرى، مقتنصًا هذه الفرصة السانحة ليحكي ويحكي: "وكان المجتمع يميّز بين امرأة وامرأة، في سجلّات المحاكم الشرعيّة، تُوصَف المرأة القرويّة أو الفقيرة بالحُرْمَة إذا كانت متزوّجة، وبالبنت أو القاصر إذا كانت غير متزوّجة، ومثل هذه الألقاب ما زالت حاضرة حتّى الآن، وفي حين أنّ ديباجة عقود الزواج للناس العاديّين خلت من الألقاب التفخيميّة، كانت عقود بنات الأعيان تضجّ بالألقاب الزاعقة، مثلًا: تاج المستورات، والجوهرة المكنونة، وذات الحجاب الرفيع، وأخت الأتراب، والدرّ المصون، والسيّدة، وعالية الرتب، وفخر المُخَدْرات، والستّ المصون، وتاج المحجّبات، وخاتون، وستّ القضاة، والمرأة الكاملة، وغيرها".
ضحكتُ لابتسامات والدي وهو يعدّد الألقاب، ولكنّه سألني:
- لماذا تضحك؟
- على النساء الـمُخْدَرات؟ هل كنّ يتعاطين المخدّرات؟
قال والدي ضاحكًا:
يا أهبل، الـمُخْدَرات هنا، من الخِدْر، وهو الفراش الآمن، والمقصود بهذا اللقب ’المستورة‘، ألم تسمع رجلًا يخاطب امرأته بالمستورة؟
وأضاف: "لم يقتصر هذا التمييز بين الفقيرات وبنات الأعيان وزوجاتهم على المسلمين، ولكنّه أيضًا امتدّ إلى المسيحيّين، فالمرأة المسيحيّة العاديّة، أُطْلِق عليها في عقود الزواج: الذمّيّة، أو الروميّة، أو القبطيّة، أو الأرمنيّة، أو الذمّيّة اليهوديّة، أو الحرمة. وإذا كانت متوفّاة يُشار إليها بالمرأة الهالكة".
- وبنات الأعيان المسيحيّات؟
- الألقاب كثيرة؛ مفخر نساء ملّتها، وبهجة نساء ملّتها، ومفخر نساء الملّة المسيحيّة، وقدوة العشيرة العيساويّة، والستّ، وبهجة نساء ملّتها...
بعد ضحكنا، ردّ والدي على بعض أسئلتي، عن نساء القدس وقراها، سألته: "ومن أين أتى اسم حُلْوَة؟".
أجابني: "هذه قصّة أخرى يا والدي، سأحكيها مرّة أخرى، وعليك الآن أن تنام".
رفضت النوم حتّى أعرف مَنْ هي حُلْوَة هذه، فرضخ والدي: "حُلْوَة، امرأة كانت حُلْوَة كما يدلّ اسمها، ولكنّها لم تواجه مخاطر جدّيّة بسبب الغيرة، وإنّما وقعت ضحيّة ظلم أصعب من الغيرة كثيرًا. هي زوجة مختار قريتنا، وخلال حرب 1948، تقدّمت العصابات الصهيونيّة لاحتلال البلدة القديمة، وطوّقوا القدس من جهات عدّة، من بينها جهة قريتنا، وتركّز الهجوم من جبل النبيّ داود، وحارة اليهود. ولأنّنا أسفل الجبل فإنّ القذائف لم تكفّ عن السقوط على قريتنا، بينما كان رجالنا يقاومون، ليس فقط في القرية، بل في المحاور المختلفة حول القدس أيضًا، ومثلما تفعل النساء في حروب الشرق، خرجت حُلْوَة مع العديد من النسوة ليشجّعن الرجال على المقاومة، ويحاولن تقديم ما يقدرن على تقديمه، مثل تزويد رجالهنّ بالماء والمؤن، وطمأنتهم على حال الصغار. لكنّ حظّ حُلْوَة لم يكن حُلْوًا؛ فأصيبت برصاص الأعداء من قنّاص يهوديّ اتّخذ من سطح قبر النبيّ داود موقعًا له، أصابت قلبها، فاستشهدت، فسُمِّي الوادي باسمها. لم يَعُدْ واديًا للنبّاحة، تخليدًا لظلم المجتمع لامرأة، ولكنّه أصبح واديًا لتخليد بطولة امرأة، كان الناس وهم يشهدون تاريخًا جديدًا يُكْتَب لقدسهم يريدون التخلّص من عار خذلانهم للنبّاحة، ويفخرون ببطولة امرأة أخرى خرجت من بينهم، أرادوا أن يتذكّروها دائمًا، ويذكّرهم الناس بها".
أخبرني والدي أنّ اليهود سيطروا على مقام النبيّ داود، وطردوا سكّان الحيّ، وظلّوا يشكّلون خطرًا على ناس قريتنا في الأسفل، ولكنّ الناس لم يفقدوا الأمل بالصعود إلى الجبل مرّة أخرى، ويزيلون الخطر وينتقمون لحُلْوَة، لكنّهم فشلوا. وفي الحرب الأخيرة، نزل يهود الجبل عن سطح مقام النبيّ داود إلى قريتنا، وبدؤوا بسرعة البحث عن آثاره، بدوا متلهّفين وسريعين، حاملين البنادق والمجارف والأموال.

كاتب وصحافيّ فلسطينيّ. عَمِلَ في عديد الصحف الفلسطينيّة والعربيّة، وصدر له أكثر من 10 كتب، منها رواية «مجانين بيت لحم» (2013)، و«الإنجيل المنحول لزانية المعبد» (2022).